من أين يستمد الكاتب مادته؟
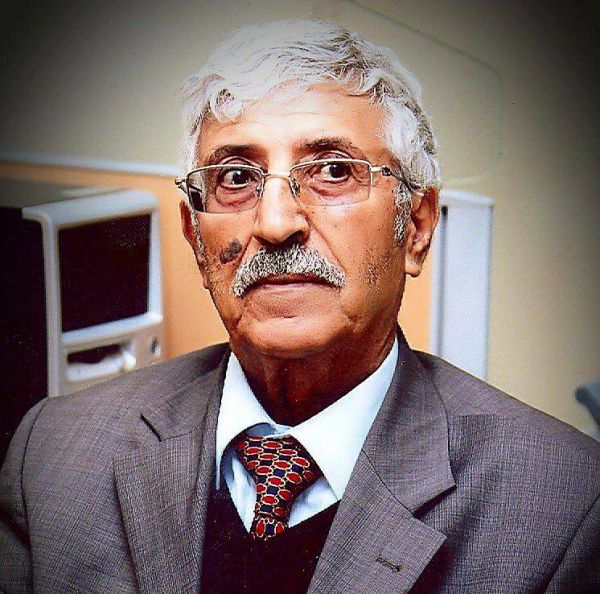
بقلم: عبدالعزير المقالح *
كل شيء في الحياة، وكل ما حول الإنسان من مشاهدَ ومرائيَ مادةٌ خصبةٌ وغنيةٌ للكاتب، ويستمد منها كل مادته الكتابية، وفيها ما هو توثيق، وفيها ما هو إبداع، ويكاد هذا الفعل الكتابي، يوحي إلى صاحبه بأنه يسيطر على ما حوله ويمتلكه ويعبر عنه. ولعل هذا الشعور الاستئثاري هو ما يمنح الكاتب قدرةً على مواصلة الكتابة، وإثبات وجوده من خلال إثبات المعاني.
وكلما ظن الكاتب أنه استنفد المعاني وجد أنها تتجدد وتتنامى، تكاد تكون بحراً يغرف منه ولا يتأثر، ولولا هذا الشعور الخلاق، لكان أي كاتب قد توقف جهدُه عند مقالة أو مقالتين، أو عند كتاب أو كتابين، لكنه ما يكاد ينتهي من عمل حتى يجد نفسه مدفوعاً إلى كتابة المزيد، وهي ميزة يتحلى بها الكتاب المبدعون الذين سبق لي في هذه الإشارات أن ذكرت بأنهم يغترفون من بحر لا تنضب مياهه.
وبعض الكتاب، كما يشير جبران خليل جبران، يعانون حيرة تجاه ما يشعرون به من استنزاف لأفكارهم، لذلك فهو يرى (إنه اللغز المحير، من لا يحظى إلاَّ بالقليل من لحظات الإبداع، ينتج الكثير، أما من يتمتع بالوعي الكامل، ويعيش الإبداع حتى في لحظات نومه، لا يستطيع إعطاء الكثير، غير أن لكل لغز حلاً وتفسيراً).
يواصل جبران فيقول: (إذا وجد فقير كنزاً، فسيغني ويفرح ويرقص، أما إذا وجد ثري هذا الكنز، فلن يحرك ساكناً، لأن لديه الكثير الكثير من الذهب والألماس والحجارة الكريمة، هكذا هو الشاعر الذي يحظى ببرهة من الإبداع، فيستفيد منها، ويستغل ما أهداه الوجود).
وهكذا فإن الكتابة، حتى الإبداعية، لا تأتي من الفراغ، وإنما من واقع الحياة ومن مؤثراتها المختلفة، وما من كاتب اعتمد على طاقته الإبداعية فقط، دون أن يستمد مقوماتها من المؤثرات التي يجدها في طريقه، أو تلك التي تحيط به من كل الجهات.
وفي إشارة ثانية، نتوقف قليلاً عند جلال الدين الرومي، لكشف المزيد من هذه الرؤى: (تحرك ضمن ذاتك ولكن إياك أن تسلك الطريق الذي يقودك الخوف إليها)، هذا ما يقوله جلال الدين الرومي. لا ريب أن لهذه الكلمات أهمية كبرى، ولنا أن نتذكر أن جلال الدين الرومي، كما يشير تاريخ حياته، قد عاش قبل نحو ألف ومئتي سنة ونيف. وحتى اليوم لايزال هناك من يتبع طريقته في الرقص.. كان يرقص وهو يلف ويدور حول جسده.. كأنه طفل صغير، يبقى يلف حول ذاته، حتى يأمره والداه بالتوقف، لئلا يصاب بالدوار، ولكن جلال الدين لم يكن قربه من يطلب إليه التوقف. ربط جلال الدين، بين التأمل والدوران حول الجسد، وهكذا، كلما أردت إطالة فترة التأمل، عليك الاستمرار في هذه القصة، ليس لساعات قليلة، بل عليك الاستمرار طالما أنت قادر على الرقص. ولكن، وبعد مرور هذه المئات من السنين، ماتزال هذه الرقصة تمارس، وهناك الآلاف ممن يمارسونها، إنها رقصة الدراويش، كما تسمى اليوم.
والدرويش هو الصوفي المعاصر، الذي لايزال يعتمد الرقص الدوراني وسيلة للتأمل.
وهناك من الكتاب من اعتاد القيام بعمل ما قبل الكتابة كالمشي لساعات طويلة، أو أداء بعض التمارين الرياضية، ويمكن القول إن لكل كاتب طريقته وأسلوبه في استدعاء الوحي، إذا جاز التعبير، ومن هنا فالفعل الإبداعي، كتابة كان أو تصويراً، ليس سهلاً ولا يهجم على الكاتب دون مقدمات.
وقد قيل إن جبران خليل جبران، على سبيل المثال، قد كتب عشرات الكتب، التي لم تترك أثراً في حياة الناس، لكن كتاباً واحداً قليل الكلمات معدود الصفحات، قد ترك أكبر أثر في ملايين الناس من مختلف اللغات، وقد قال عنه أحد الكتاب (كتب جبران ثلاثين كتاباً، ولكن كتابه (النبي) كان الأبرز والأكثر تميزاً، كتب بعده الكثير، لكنه لم يتوصل في أي كتاب للجمال والصدق والحقيقة كما في «النبي»). وقد تُرجم (النبي) إلى جميع لغات العالم، ولايزال، حتى اليوم، الكتاب الأكثر مبيعاً، ويكمن جماله في أنك لن تلحظ فيه أي وجود إلاَّ لجبران. كثيرون يعتبرون كتاب (النبي)، وأنا واحد منهم، أكثر قداسة من أي كتاب دنيوي آخر.
وقد سبق لي في هذه التداعيات، أن أشرت أكثر من مرة إلى أن الكاتب لا ينطلق من فراغ ولا يحضر أفكاراً من العدم، بل عليه أن يقرأ كثيراً ويتابع أحداث الحياة، لكي يجد فيها ما يهمه ويهم القارئ، وإلاَّ فإن ما يكتبه لا يلفت انتباه أحد، ومن حسن حظنا في هذا الفترة الزمنية، أن توافرت لنا من المراجع القديمة والحديثة، ما يجعلنا نتحرك في مناخ آهِلٍ بكل ما يعنينا ويعني القارئ، ولنا أن نعود إلى أحد مشاهير الكتاب لنستعين بوجهة نظره في هذا المجال، وهذا الكبير هو سقراط، فقد ضحى بنفسه من أجل العلم والحقيقة، ودخل التاريخ من أوسع أبوابه، وكما يقول أحد مؤرخي حياته: ( كلكم اليوم تستفيدون من العلم وإنجازاته، ولكن ما من أحد يعلم أن سقراط ضحى بنفسه إكراماً لعين العلم). لم يطلب إلاَّ أمراً واحداً: ألاَّ نقتنع بشيء، وألاَّ نجعله مسلماً بها، إلاَّ بعد إخضاعه للتجربة والاختبار.. إلاَّ بناءً على براهين وأدلة.. لأن ما تقبله هكذا، هو حقيقة افتراضية، قد تبزغ شمس الغد، وتكشف لنا أنه مجرد فرضية واهية، يصبح ما كان حقيقة مسلماً بها، زيفاً وزوراً.
ما من أحد سعى إلى الحقيقة وبحث عنها كسقراط، حتى لو تمكنت من الوصول إلى الحقيقة، أو ما اعتقدت أنه الحقيقة المطلقة، الحقيقة التي يستحيل ألاَّ تكون غير ذلك.. فما عليك، بناءً على مقتضى العلم، أن تتقبله كفرضية، لأن كل يوم هناك اكتشاف جديد، قد يقلب (حقيقتك) إلى لا حقيقية. على المرء أن يكون دائم الاستعداد للتطور، للتعرف إلى حقائق جديدة، فلا شيء مطلقاً في هذا العالم، علينا ألاَّ ننسى، أن سقراط عاش قبل خمسة وعشرين قرناً ونيف، وبرغم ذلك سمحت له جرأته، لحظة جرع السم، أن يجمع تلاميذه ويقول (كنتم دائماً تتساءلون، عما إذا كانت هناك حياة بعد الموت.. ها هي الفرصة الذهبية أمامكم، فلو مت ميتة عادية ما كنتم قادرين على معرفة شيء، ولكن السم سيعطى لي الآن، والسم يقتل ببطء شديد، لهذا سأخبركم بكل ما أشعر به حتى اللحظة التي يتيبس بها لساني فلا أعود قادراً على النطق). وتأتي العبرة هنا من أن على الفكر الحق، أن يتحمل تبعة أفكاره، من دون تبرم أو اعتذار، المفكرون الذين خلدهم التاريخ، هم أولئك الذين لم يستسلموا ولم يخافوا المصير المحتوم، الذي ينتظره كل مفكر شجاع.
* مجلة الشارقة الثقافية




